
سوريا: مراكز بيع «الوهم» في بلد المليون إعلامي!بقلم: صدام حسين
الثلاثاء, 23 تموز 2019 الساعة 19:01 | مواقف واراء, زوايا

جهينة نيوز
لكل مواطن سوري مهنتان، مهنته الأصلية، والإعلام، مقولة ربما تنطبق على الحالة الإعلامية الراهنة في سوريا. هكذا أصبح الإعلام مهنة من لا مهنة له في بلد المليون إعلامي، وانتشرت «مهنة المتاعب» كالنار في الهشيم في صفوف السوريين من كل الأعمار، ولدى سؤال أي سوري عن الهواية التي يرغب في ممارستها يقول بلا تردد إنها «الصحافة»، ويؤكد أنه كان يرغب بدراسة الإعلام، ولكن الظروف حالت دون ذلك.
عجزت كلية الإعلام في جامعة دمشق عن استقبال الكم الهائل من الطامحين إلى الالتحاق بركب «السلطة الرابعة»، وهنا تكاثرت مراكز التدريب الإعلامي، التي لعبت على «وتر» حب الشهرة والظهور لدى معظم هؤلاء.
أصبح أمراً مألوفاً في دمشق أن يعطيك أحد الشبان على الطريق إعلاناً لدورة تدريبية بـ 50 ألف ليرة سورية، لإتباع دورة في أحد مجالات الإعلام، والتي تتنوع حسب الـ menu بين الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، وتصل قائمة الرغبات إلى أدق التفاصيل في التقديم التلفزيوني وعمل المراسل.
تركز هذه المراكز على الأسماء اللامعة من الإعلاميين والإعلاميات لجذب أكبر عدد من المتدربين، وعلى مبدأ تعلم اللغة الإنكليزية في خمسة أيام، فإن أقل 100 دولار فقط، قادرة على تحويل «ربة منزل» تحمل شهادة إعدادية إلى إعلامية في ليلة وضحاها. يوحي المشهد الرسمي الأخير لتوزيع الشهادات في هذه المراكز وابتسامات «الثقة» المتبادلة بأن أصحابها أحدثوا نقلة نوعية في حياة الملتحقين بهذه الدورات السريعة، وأن هذه الشهادة المصدقة من وزارة الخارجية كافية لخوض غمار سوق العمل الإعلامي في سوريا والعالم!
وكدليل على مستوى الانحدار التجاري في هذا المجال، انتشر إعلان لإحدى الدورات مؤخراً في دمشق بنحو 500 ليرة (أقل من دولار واحد) لتعلم أصول الإعلام الإلكتروني!
وبعد افتتاح قسم الإعلام في ثمانينيات القرن الماضي وتحوله إلى كلية مستقلة بأربعة تخصصات قبل نحو 10 سنوات، تخرج المئات من الطلاب، وبعضهم يحملون شهادة الماجستير، وبسبب محدودية عدد وسائل الإعلام في سوريا بقي معظم هؤلاء جالسين في منازلهم ينتظرون أي فرصة للعمل في تخصصهم، بينما فقد آخرون الأمل واتجهوا إلى مجالات أخرى.
وخلال السنوات الماضية، أضيف إلى هؤلاء، آلاف الخريجين من مراكز التدريب الإعلامي، الذين تعرضوا لصدمة سوق العمل، وشعروا بأنهم اشتروا شهادات في «الوهم»، فيما شكل التحاق بعضهم بالعمل الإعلامي «كارثة» مهنية.
وكنتيجة مباشرة لدخول هؤلاء مجال الإعلام، ازدادت انتهاكات المهنة على نحو غير مسبوق، واختلط عمل الصحافي بـ «المحلل» وأصبح رأيه أهم من الحدث، وانحدر الصحافة الفنية إلى مستوى «فانز» الفنانين، وأصبح أقصى طموح الصحافي التقاط «سيلفي» مع فنان أو فنانة.
وتحول الصحافي الميداني إلى مقاتل على الجبهة، وهبط خطابه من الإنسانية إلى دعوات «الإبادة» والتطهير العرقي، من دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه حياة المدنيين.
أما صحافي المحليات، فقد تحول إلى «معقب معاملات» يلمع صور المسؤولين لتسهيل «البزنس» الخاص به، في حين نزع محرر الشؤون الاقتصادية ثوب الموضوعية وارتدى ثوب «سمسار العقارات».
يقول مصدر في وزارة الإعلام السورية لـ «الأخبار» إن الوزارة منعت هذه الدورات وحصرتها بموافقتها، واشترطت أن يكون المدرب معتمداً من قبل وزارة التنمية الإدارية، وأنها تعتمد معايير دولية بالنسبة لاختيار المدربين، والمدرب من دون شهادة لا يعد مدرباً.
ولكن المصدر يعترف بأن هذه القرار لا يزال «حبراً على ورق»، وهذه الدورات خاضعة الآن للمحسوبيات وقرارات «المتنفذين»، وهي في الغالب لا تهتم بمستوى المدرب ولا المحتوى الذي يقدمه وأصبحت نشاطاً تجارياً بحتاً.
في الألفية الثالثة، باتت البيئة الإعلامية مفتوحة للجميع، ليس فقط في سوريا، بل في العالم كله بسبب سهولة استخدام التكنولوجيا وانتشار مفهوم «المواطن الصحافي» خصوصاً في فترات الحروب التي يكون فيها الجمهور متعطشاً للمعلومة من أي مصدر كان، وهذا ما يفسر ظهور كم هائل من الأشخاص الذين يدّعون ممارسة العمل الصحفي.
ويرى أصحاب هذا الموقف أن فوضى الدورات أمر طبيعي مع ديمقراطية انتشار وسائل الإعلام، وكسر جميع الحواجز بين الإعلام التقليدي والجمهور عبر السوشال ميديا، ما أدى إلى استسهال اتخاذ قرار الدخول إلى عالم الصحافة من كل شخص لديه الرغبة في قول شيء ما. من يسمح لشخص لا يملك شهادة في الطب مثلاً بإجراء عملية جراحية، مهما بلغت درجة موهبته، فما بالك بمن يتوجه لملايين البشر؟، ويمكن القراءة في مجزرة رواندا التي تسببت بها مذيعة قرأت خبراً يتضمن خطاب كراهية عبر الراديو، وأدت إلى مقتل مليون إنسان!
المصدر: جريدة الاخبار
أخبار ذات صلة
جهينة نيوز
لكل مواطن سوري مهنتان، مهنته الأصلية، والإعلام، مقولة ربما تنطبق على الحالة الإعلامية الراهنة في سوريا. هكذا أصبح الإعلام مهنة من لا مهنة له في بلد المليون إعلامي، وانتشرت «مهنة المتاعب» كالنار في الهشيم في صفوف السوريين من كل الأعمار، ولدى سؤال أي سوري عن الهواية التي يرغب في ممارستها يقول بلا تردد إنها «الصحافة»، ويؤكد أنه كان يرغب بدراسة الإعلام، ولكن الظروف حالت دون ذلك.
عجزت كلية الإعلام في جامعة دمشق عن استقبال الكم الهائل من الطامحين إلى الالتحاق بركب «السلطة الرابعة»، وهنا تكاثرت مراكز التدريب الإعلامي، التي لعبت على «وتر» حب الشهرة والظهور لدى معظم هؤلاء.
أصبح أمراً مألوفاً في دمشق أن يعطيك أحد الشبان على الطريق إعلاناً لدورة تدريبية بـ 50 ألف ليرة سورية، لإتباع دورة في أحد مجالات الإعلام، والتي تتنوع حسب الـ menu بين الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، وتصل قائمة الرغبات إلى أدق التفاصيل في التقديم التلفزيوني وعمل المراسل.
تركز هذه المراكز على الأسماء اللامعة من الإعلاميين والإعلاميات لجذب أكبر عدد من المتدربين، وعلى مبدأ تعلم اللغة الإنكليزية في خمسة أيام، فإن أقل 100 دولار فقط، قادرة على تحويل «ربة منزل» تحمل شهادة إعدادية إلى إعلامية في ليلة وضحاها. يوحي المشهد الرسمي الأخير لتوزيع الشهادات في هذه المراكز وابتسامات «الثقة» المتبادلة بأن أصحابها أحدثوا نقلة نوعية في حياة الملتحقين بهذه الدورات السريعة، وأن هذه الشهادة المصدقة من وزارة الخارجية كافية لخوض غمار سوق العمل الإعلامي في سوريا والعالم!
وكدليل على مستوى الانحدار التجاري في هذا المجال، انتشر إعلان لإحدى الدورات مؤخراً في دمشق بنحو 500 ليرة (أقل من دولار واحد) لتعلم أصول الإعلام الإلكتروني!
وبعد افتتاح قسم الإعلام في ثمانينيات القرن الماضي وتحوله إلى كلية مستقلة بأربعة تخصصات قبل نحو 10 سنوات، تخرج المئات من الطلاب، وبعضهم يحملون شهادة الماجستير، وبسبب محدودية عدد وسائل الإعلام في سوريا بقي معظم هؤلاء جالسين في منازلهم ينتظرون أي فرصة للعمل في تخصصهم، بينما فقد آخرون الأمل واتجهوا إلى مجالات أخرى.
وخلال السنوات الماضية، أضيف إلى هؤلاء، آلاف الخريجين من مراكز التدريب الإعلامي، الذين تعرضوا لصدمة سوق العمل، وشعروا بأنهم اشتروا شهادات في «الوهم»، فيما شكل التحاق بعضهم بالعمل الإعلامي «كارثة» مهنية.
وكنتيجة مباشرة لدخول هؤلاء مجال الإعلام، ازدادت انتهاكات المهنة على نحو غير مسبوق، واختلط عمل الصحافي بـ «المحلل» وأصبح رأيه أهم من الحدث، وانحدر الصحافة الفنية إلى مستوى «فانز» الفنانين، وأصبح أقصى طموح الصحافي التقاط «سيلفي» مع فنان أو فنانة.
وتحول الصحافي الميداني إلى مقاتل على الجبهة، وهبط خطابه من الإنسانية إلى دعوات «الإبادة» والتطهير العرقي، من دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه حياة المدنيين.
أما صحافي المحليات، فقد تحول إلى «معقب معاملات» يلمع صور المسؤولين لتسهيل «البزنس» الخاص به، في حين نزع محرر الشؤون الاقتصادية ثوب الموضوعية وارتدى ثوب «سمسار العقارات».
يقول مصدر في وزارة الإعلام السورية لـ «الأخبار» إن الوزارة منعت هذه الدورات وحصرتها بموافقتها، واشترطت أن يكون المدرب معتمداً من قبل وزارة التنمية الإدارية، وأنها تعتمد معايير دولية بالنسبة لاختيار المدربين، والمدرب من دون شهادة لا يعد مدرباً.
ولكن المصدر يعترف بأن هذه القرار لا يزال «حبراً على ورق»، وهذه الدورات خاضعة الآن للمحسوبيات وقرارات «المتنفذين»، وهي في الغالب لا تهتم بمستوى المدرب ولا المحتوى الذي يقدمه وأصبحت نشاطاً تجارياً بحتاً.
في الألفية الثالثة، باتت البيئة الإعلامية مفتوحة للجميع، ليس فقط في سوريا، بل في العالم كله بسبب سهولة استخدام التكنولوجيا وانتشار مفهوم «المواطن الصحافي» خصوصاً في فترات الحروب التي يكون فيها الجمهور متعطشاً للمعلومة من أي مصدر كان، وهذا ما يفسر ظهور كم هائل من الأشخاص الذين يدّعون ممارسة العمل الصحفي.
ويرى أصحاب هذا الموقف أن فوضى الدورات أمر طبيعي مع ديمقراطية انتشار وسائل الإعلام، وكسر جميع الحواجز بين الإعلام التقليدي والجمهور عبر السوشال ميديا، ما أدى إلى استسهال اتخاذ قرار الدخول إلى عالم الصحافة من كل شخص لديه الرغبة في قول شيء ما. من يسمح لشخص لا يملك شهادة في الطب مثلاً بإجراء عملية جراحية، مهما بلغت درجة موهبته، فما بالك بمن يتوجه لملايين البشر؟، ويمكن القراءة في مجزرة رواندا التي تسببت بها مذيعة قرأت خبراً يتضمن خطاب كراهية عبر الراديو، وأدت إلى مقتل مليون إنسان!
المصدر: جريدة الاخبار
اقرأ المزيد...

 الدور الوظيفي للسلطة السورية في معادلات الصراع الجديدة بالشرق الأوسط
الدور الوظيفي للسلطة السورية في معادلات الصراع الجديدة بالشرق الأوسط  وفيق صفا... الصندوق الأسود الذي أصبح عبئاً على حزب الله
وفيق صفا... الصندوق الأسود الذي أصبح عبئاً على حزب الله  بين شهادات الدكتوراه وورقة محروقة: من يحاول تشويه صورة الساحل السوري؟؟
بين شهادات الدكتوراه وورقة محروقة: من يحاول تشويه صورة الساحل السوري؟؟  قبيل أيام من انتهاء مهلته... ما مصير اتفاق مارس بين الحكومة السورية وقسد؟
قبيل أيام من انتهاء مهلته... ما مصير اتفاق مارس بين الحكومة السورية وقسد؟  حلّ الجيش السوري.. سيناريو عراقي مجرَّب... بقلم: ليلى نقولا _ أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية
حلّ الجيش السوري.. سيناريو عراقي مجرَّب... بقلم: ليلى نقولا _ أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية  حول آخر التطورات في شمال سورية.. بقلم نارام سرجون
حول آخر التطورات في شمال سورية.. بقلم نارام سرجون  نَعَمْ نَصْرٌ مرٌّ - بقلم النائب محمد رعد
نَعَمْ نَصْرٌ مرٌّ - بقلم النائب محمد رعد  ضمانة حفظ السيادة.. معادلة الشعب والجيش والمُقاومة - بقلم النائب محمد رعد
ضمانة حفظ السيادة.. معادلة الشعب والجيش والمُقاومة - بقلم النائب محمد رعد  كوبا: دروس مستفادة -بقلم: أ.د بثينة شعبان
كوبا: دروس مستفادة -بقلم: أ.د بثينة شعبان  محمد بن سلمان لبلينكن: لا لاتفاق سلام مع إسرائيل… نعم للاستثمار في سوريا في مقابلته الأخيرة مع قناة سي ان ان الأميركية
محمد بن سلمان لبلينكن: لا لاتفاق سلام مع إسرائيل… نعم للاستثمار في سوريا في مقابلته الأخيرة مع قناة سي ان ان الأميركية  من الفقر العام إلى الفقر المدقع: درَك جديد في الهاوية السورية. بقلم: زياد غصن
من الفقر العام إلى الفقر المدقع: درَك جديد في الهاوية السورية. بقلم: زياد غصن  في حضرة الرئيس الأسد.. حوار سياسي يضع الإعلاميين في عمق الموقف
في حضرة الرئيس الأسد.. حوار سياسي يضع الإعلاميين في عمق الموقف  قاسم سليماني.. الشاهد والشهيد.. بقلم/ د. وليد القططي
قاسم سليماني.. الشاهد والشهيد.. بقلم/ د. وليد القططي  إليزابيث.. الموت في لندن والحِداد في عمّان بقلم الدكتور وليد القططي
إليزابيث.. الموت في لندن والحِداد في عمّان بقلم الدكتور وليد القططي 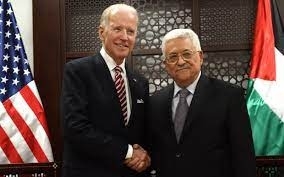 لقاء عباس-بايدن.. سيرٌ عكس نداء الوطن
لقاء عباس-بايدن.. سيرٌ عكس نداء الوطن  إيران تستهدف سفينة CIF التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
إيران تستهدف سفينة CIF التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
 الحرس الثوري: مضيق هرمز سيظل مغلقاً وفق توجيهات المرشد الجديد
الحرس الثوري: مضيق هرمز سيظل مغلقاً وفق توجيهات المرشد الجديد
 السيد مجتبى حسيني خامنئي يصدر البيان الأول: ابطالنا أزالوا من الأعداء وهم السيطرة على وطننا
السيد مجتبى حسيني خامنئي يصدر البيان الأول: ابطالنا أزالوا من الأعداء وهم السيطرة على وطننا
 الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية في الخليج العربي
الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية في الخليج العربي
 صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل احتجاز مادورو في زنزانة انفرادية
صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل احتجاز مادورو في زنزانة انفرادية
 وزير المالية: استئناف تسديد الرواتب التقاعدية لعدد من الفئات قريباً
وزير المالية: استئناف تسديد الرواتب التقاعدية لعدد من الفئات قريباً
 إسرائيل تشن موجة غارات واسعة على جميع أنحاء إيران
إسرائيل تشن موجة غارات واسعة على جميع أنحاء إيران
